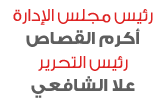من أبرز ما ذكره الكاتب عبد الرحيم كمال، فى الندوة التى اشتركت فيها فى جريدة «اليوم السابع» حول مسلسل الحشاشين، أنه «دراماتورجى» وليس مؤرخا، لا يتجاهل الأحداث التاريخية المحورية، ولكن لديه هامش فى السرد والخيال، أى أنه يجمع ما بين الأمرين فى سرد حكاية حسن الصباح.
ومن أطرف ما ذكره فى هذا السياق للتدليل على فكرته، أن شخصية زيد بن سيحون التى لعبها ببراعة أحمد عيد لا وجود لها فى التاريخ، وأنها شخصية درامية خيالية تماما، بينما معظم مشاهدها كانت مع حسن الصباح، وهو شخصية لها أصل تاريخى.
الحقيقة أن المشاهد لن يستطيع أن يكتشف تنافرا فى المسلسل، كما هو الحال فى أى دراما تاريخية ناضجة، بين استلهام شخصية من التاريخ، واستلهام شخصية من الخيال، وهذا بالضبط دور «الدراماتورجى» الذى يكتب دراما بالأساس، ويعيد بناء وهضم وصياغة كل ما قرأ من مراجع، يختار ويحذف، يملأ فراغات، ويوصل خطوطا وعلاقات مسكوت عنها، يختزل الأزمنة ويكثّقها، ويجعلنا نرى الأحلام والكوابيس والهلاوس، ونشاهد ما سيحدث فى المستقبل، أو ما يطلقون عليه تكنيك «الفلاش فوروارد»، ويمزج كذلك بين حدثين تاريخيين فى فترة متقاربة، ويتخيّل لقاءات وحوارات بين الشخصيات، ويصنع صراعا موازيا للصراع التاريخى، ويضع الأفكار فى ثنايا المواقف، ويحملها على أجنحة التفاصيل والأحداث.
قلت فى الندوة إن «الدراماتورجى» لا يقوم بمسرحة «منهج التاريخ»، كما تفعل المسرحيات المدرسية البدائية، الساذجة والمباشرة، ولكنه يصنع بناء كاملا موازيا، فى إطار فكرة عامة، ورؤية تخصه، فهذا ليس درسا فى التاريخ، ولكنه رؤية المؤلف الفنية والدرامية والاجتماعية والسياسية لما قرأ فى هذا التاريخ.
لا وجود للموضوعية فى الفن، ولكن المؤلف يحافظ على ملامح عامة، وأحداث تاريخية أساسية محورية، ثم يصنع منها عالما متسقا فى عناصره، ولا يتردد فى ابتكار الشخصيات والمواقف، وزرعها ضمن هذا البناء، كما حدث فى شخصية زيد بن سيحون.
المهارة والشطارة ألا تشعر بأن الشخصية غريبة اسما ورسما وتصرفا وسلوكا عن أجواء الفترة والمكان والزمان، والأهم من ذلك، أن يكون لها دور فى الدراما، مثل شخصيات خيالية كثيرة فى المسلسل، لا تستطيع أن تفرقها عن شخصيات لها مرجعية تاريخية.
يفكر كاتب الدراما أن حسن الصباح كان له تابع مقرب، له دور أكبر من سواه، ولا بد أن يرسم للتابع ملامح وتفاصيل، وأن يكون له ملف عن تكوينه وأصله وفصله وبدايته ونهايته وأفكاره وطباعه ونقاط ضعفه وقوّته، وأن يساهم دوره فى دفع الأحداث إلى الأمام، وقراءة شخصية وأفكار حسن الصباح نفسه.
التاريخ لا يكتب كل شىء، والشخصيات العادية نادرا ما تظهر على صفحاته، الكلام كله عن الشخصيات الكبيرة، عن الأبطال والمؤثرين، بينما تنقل الدراما صورة شاملة، تجمع بين الأبطال والناس العادية، بل إن إضافة الدراما الحقيقية فى تحليل الشخصيات عموما، وفى اكتشاف الإنسان بكل تناقضاته، فى اللون الرمادى، وليس فى الأبيض والأسود، الذى يطبع الشخصيات فى كتب التاريخ.
يهتم المؤرخ أكثر بالحدث وبالنتيجة، ولكن كاتب الدراما يسأل عن دوافع السلوك، وعن طبيعة الشخصية، وعن لحظات التحول.
يتوقف كاتب الدراما طويلا عند الظروف والملابسات، وعند الإنسان ككائن معقد، لا يمكن تلخيصه فى سطرين، أو فى معركة حربية انتصر أو انهزم فيها.
قلت فى الندوة: إن أحد الفوارق الجوهرية بين المؤرخ و«الدراماتورجى» هى أن المؤرخ يكتب فقط عما حدث بالفعل، بينما يكتب الدراماتورجى عما حدث بالفعل، ويكتب أيضا عما يحتمل حدوثه دراميا فى الوقت نفسه، وهو يرجح اختياره من التاريخ بما يفيد الدراما وتأثيرها، يعنى مثلا لو كانت هناك روايات متناقضة حول صداقة الصباح والخيام ونظام الملك، فهو يميل إلى تأكيد صداقتهم وخلافهم، لأن ذلك يبرز الصراع، ويفيد معنى الدراما كلها.
ضربت مثلا فى الندوة بأن بعض المؤرخين ينكرون مثلا أن يكون يوليوس قيصر قد قال أثناء قتله مستنكرا: «حتى انت يابروتس؟!!!»، وقلت إنه حتى لم يكن قالها فى الواقع، فيجب أن يقولها دراميا فى تلك اللحظة المؤلمة.
هل يقولها هنا بأمر التاريخ؟
أبدا.. إنه يقولها بأمر الفن والدراما، وقد أثبت شكسبير تحديدا أن الفن والدراما أهم من الواقع، الفن هو الذى يخلّد الواقع، و«هاملت» مثلا صار أيقونة السؤال الوجودى، ولا أظنه كان شخصية مهمة فى تاريخ الدنمارك، وأصبحت كل شخصية تاريخية استلهم شكسبير حياتها، أسئلة كبرى إنسانية، ونماذج درامية خالدة.
المؤلف الدرامى يستدعى التاريخ من باب الأسئلة المعاصرة، وهو لا يريد أصلا أن يكون مؤرخا، ولكنه يريد أن يطرح أسئلة تشغله، من خلال أحداث التاريخ، ويمتلك بصيرة نافذة فى قراءة الحاضر والمستقبل أيضا، ومازلت أندهش من رؤية وحيد حامد المذهلة فى فيلم «طيور الظلام »، التى تحققت حرفيا فيما بعد، وكنا نظن أنه يبالغ فى رؤية الكارثة وقت عرض الفيلم.
ضربت مثلا آخر بالمشهد الافتتاحى فى فيلم «نابليون » للمخرج ريدلى سكوت، عندما يظهر الضابط الصغير نابليون بونابرت وهو يشهد إعدام مارى أنطوانيت، وقد كتبوا فى بعض الصحف وقتها إن هذا المشهد لم يحدث تاريخيا، وكان رد المخرج ساخرا وعنيفا، ولم يكلف نفسه حتى بأن يشرح الضرورة الدرامية التى استدعت هذا الجمع بين نابليون ومارى أنطوانيت فى مشهد واحد، وكأنه يرى أن إثارة هذا الأمر، بعد هذا التاريخ الطويل من الدراما، لهو أمر معيب، ولا يصح الجدل بشأنه.
لو كتب «الدراماتورجى» على طريقة ومنهج المؤرخ ستكون كارثة، وسنصبح أمام حصة تاريخ ممثلة على الشاشة، ولو كتب المؤرخ بخيال «الدراماتورجى»، فاخترع شخصيات لا وجود لها، وأضافها للتاريخ فهى أيضا كارثة، لأنه كما ذكرت، يكتب فقط عما حدث بالفعل، أو عما تؤكد الروايات والشهادات والوثائق حدوثه.
الغريب حقا أن فكرة الاستلهام الفنى والشعبى للتاريخ قديمة للغاية، ولعلها من عمر الحكايات والملاحم الشعبية، وأعتبر أن من كتبوا هذه الملاحم، أو شاركوا فى صياغتها واكتمالها، من كتّاب الدراما الكبار، وكانوا يعملون بالفطرة فى الانتقال بشخصيات وأحداث لها أصل واقعى وتاريخى، مثل «السيرة الهلالية » و «سيرة الظاهر بيبرس »، إلى عالم فيه الكثير من الخيال والابتكار الفنى والسردى.
المدهش أن الجمهور نفسه تجاوب مع هذا الاستلهام، بل إن الجمهور وإقباله على هذه السير والملاحم، هو الذى حفظها، ولا أتصور مثلا أن شاعرا للربابة قد توقف عن سرد حكاية الظاهر بيبرس، لمجرد أن مستمعا قال له: «الملك الظاهر بيبرس لم يقل ذلك فى كتب التاريخ »، ولكن شاعر الربابة والجمهور معا كانوا يدركون على نحو ما أنهم لا يستمعون إلى التاريخ، ولكنهم يستمتعون برؤية فنية ودرامية للتاريخ.
ومع ذلك، التمست العذر للناس فى الندوة فى هذا الخلط بين التاريخ والدراما، فهذا الخلط موجود أحيانا فى الغرب، وإن كان بالطبع بدرجة أقل بكثير.
الناس معذورة لأن التعليم يقدم التاريخ أصلا بطريقة خاطئة، فلا يعرف التلميذ إلا شخصيات متناثرة هائمة فى الفراغ، ولا يقرأ إلا عن دولة قامت، ودولة سقطت، ولا يرى سوى معارك وحروب، دون أن يفهم القوانين والأفكار والفلسفات التى تحكم حركة التاريخ، ودون أن يخرج بجملة مفيدة، أو نظرة نقدية، أو قدرة على المقارنة والفرز والحكم.
أما الدراما «ماهيتها وتاريخها وعناصرها وأصولها »، بل ودراسة الفنون عموما، فلا وجود لها تقريبا فى مناهج وحصص التعليم.
لا مسرح ولا موسيقى، ولا حصة رسم أو أشغال، لا شىء على الإطلاق إلا قشور معلومات بائسة، يتم تلقينها وحشرها فى الأدمغة، تنفّر الطالب من العلم ومن الفن ومن المدرسة ومن الحياة نفسها.
رغم هذا الفراغ المعرفى المروّع، أحمد الله كثيرا أن لدينا مسلسلا مثل «الحشاشين »، دفع الناس أن تسأل وتستفهم عن الدين والسياسة والباطنية والسلاجقة والفراسة وقراءة الوجوه والخيمياء والحسن الصباح ونظام الملك وعمر الخيام، وأتاح فرصة للحوار حول الدراما والتاريخ ولغة الحوار وبناء الشخصيات والصراع الخيالى والواقعى.. إلخ.
أثق فى أن الناس تحب أن تعرف، وأنها يمكن أن تهتم، ولديها العقل وأجهزة الاستقبال التى تستوعب وتعى وتدرك، بشرط أن نقدم لها ما يساعدها على التفكير والاهتمام، وما يجعلها قادرة على اكتشاف ما تمتلكه من أحساسيس وعقول وأذواق.
كل هذه الأمور فى داخل الناس ومخلوقون بها، علينا فقط أن نغذيها بالأفضل والأجمل.

محمود عبد الشكور

العدد الورقي من اليوم السابع