تتذكرون معى "حبيبتى.. من تكون؟ رائعة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وآخر ما تغنى به منذ ما يقرب من أربعين عامًا مضت، فكانت وداعه الأخير الذى سطره فى "أوتجراف" عشاق هذه الحقبة النابضة بثراء القلوب والسرائر، وعلى أنغامها المتهدجة ووداع "حليم" الدافئ تمايل أمام أعينى ذلك التساؤل الحائر.
"مُلهِمَتى.. من تكون؟"، فهل من مجيب يروى ظمأ السائل؟.. سائل الهوى الهائم على وجهه فى صحراء الجفوة الشعورية، فإذا بمائه العذب يوشك على النضوب، ويدنو إبداعه من القاع، وتجف شرايينه الدافئة.
أين "الملهمة" التى كانت تُشِعل جذوة الإبداع وينهل من ينبوعها الشعراء والأدباء وذوو الموهبة فى شتى الفنون؟ ومتى وكيف ارتحلت ثقافة "الإلهام" دون سابق إنذار لتوقظ نخبة المبدعين على غياب محرك شعورى فاعل له لمسته الخاصة على أعمالهم؟ والإلهام سواء كان بالإشباع أو بالحرمان.. بالعطاء أو بالحَجب كان يفرز مذاقًا روحيًا يستشعره المتلقى بنفس درجة حرارة صاحبه، لذا كان إرثنا القديم مُبَصَم برواده.
تلك "الملهمة" التى يتراقص على وحيها ابداع فريد، تارة شعرًا وتارة نغمًا، تحلو القصائد مع سطوعها وينزف القلم كلمات فى غروبها، تصنع مجدًا زاهيًا عبر إطلالتها ثم تتهاوى معها الخطوط وتتمازج الالوان صانعةً أعمق اللوحات.
وهنا أتوقف كثيرًا عند أصحاب تلك الحالة المجردة ممن خلَدوا قصصهم فى الوجدان وكان لإلهام الحبيبة دور البطولة المطلقة، فتراقَصت أمامى "كابيلز" الثلاثينيات والخمسينيات والسبعينيات بمذاقها المختمِر على أنغام فالس "الدانوب الأزرق" ثم سألت نفسى من أين لنا الآن بهؤلاء؟ فثقافة الإلهام أصبحت عاقرًا لا ولد لها ولا ابنه، ولم تعد تَحلُو ليالينا بمثل هذه النشوة الخاصة فى رحاب وحى الملهمة وإبداع المتيم!
وأخذتنى جولة شَجية أبحرت فى موجها، لِأرسو على ضفاف هؤلاء، وإذا بشراعى يهدينى لشاطئى الأول فأقف إجلالاً لرمز التحدى ومثال الجلد الصامد عميد الأدب العربى "طه حسين" الذى عاش قصة حب أعتقد أن كثير من المبصرين لم ينعموا بمثلها.. "سوزان" صاحبة الإلهام الدائم والمتجدد فى ظلمات حياه العبقرى الفذ طه حسين ومبعثه الدائم لتحدى إعاقته وما ألحقته به من طعنات مستترة أشعرته بذلك الفارق الفسيولوجى البحت بينه وبين المبصرين، فلولا سوزان ما تدفق أبداع طه حسين، فكان هناك توافق عجيب بين روحيهما كالصديقين الحميمين، لم ير ملامح وجهها ولكنه حفظ نبرة صوتها عن ظهر قلب لتكون كلمة سره فى كل يوم إبداعى يعيشه، وكتب لها فى إحدى رسائله العاشقية التسعين: «هل أعمل؟ وكيف أعمل بدون صوتك الذى يشجعنى وينصحني، بدون حضورك الذى يقويني؟".
وتقص سوزان كيف كان يتلاشى أمامها عميد الأدب العربى وهو يمد ذراعيه إليها مقدمًا أخر ما صَدر له من كُتب، وإذا بحركة يديه ترتبك كما لو كان يقدم لها شيئًا ضئيلاً، وتصف مدى تواضعه الشديد أمام غرامه بها ومدى ثبات هذا التواضع الذى لم يتزعزع يومًا، فلم تتغلب عليه الأنا يومًا لتنتصر على عاطفته.
وبعد أن رحل طه حسين كتبت الملهمة والزوجة والصديقة والحبيبة "سوزان" كتابًا فى وداعه بعنوان "معك" تسرد فيه كيف كانت رحلتهما الزاخرة بالعطاء والإبداع المتدفق، وتصف كيف يمكن أن تغار البشرية من حب كحب طه حسين لها وتذكر أقوى رسائله لها والبالغ عددهم تسعين رسائلة والتى يقول فى إحداها: "بدونك أشعر أنى أعمى حقًا، أما وأنا معك، فإنى أتوصل إلى الشعور بكل شيء، وامتزج بكل الأشياء التى تحيط بي، ابق، لا تذهبي، سواء خرجت أو لم أخرج، أحملكِ فيّ، أحبكِ. ابق، ابق، أحبكِ" وظلت سوزان محتفظة بتلك الرسائل وكانت تكتب له رسائل موازية ولكن بعد أن استقر بالعالم الآخر حيث لا يوجد ساعى بريد، ومما سطرته فى وداعه : «ذراعى لن تمسك بذراعك أبدًا، ويداى تبدوان لى بلا فائدة بشكل محزن، فأغرق فى اليأس، أريد أن أرى تحت جفنيك اللذين بقيا محلقين، ابتسامتك المتحفظة، ابتسامتك المبهمة، الباسلة، أريد أن أرى من جديد ابتسامتك الرائعة".
ثم رست سفينتى تلتقط أنفاسها من إبحار هذه العلاقة السامية لتستقر بشاطئى الثانى الذى أسكننى لأتأمل "عبقرية الزمان" الكاتب والأديب والشاعر "عباس محمود العقاد" ذلك الرجل الخشن ذو العقلية المركبة والعميقة التى يُخَيل للبعض انه من الصعب أن يكون له ملهمة، فكان مطعونًا بسهام الحب من طرف واحد، ورغم كثرة علاقاته العاطفية وتجارب الحب التى مر بها إلا أن قصة حبه الشهيرة لتلك المرأة اللبنانية التى وثَق عشقه لها فى روايته "سارة" ظلت نصلاً يعذبه ويستفز إبداعه، كما كانت الأديبة المشهورة «مى زيادة» من العلاقات العذرية الأهم والأشهر فى حياة "العقاد" حيث عرف قلبه الطريق إلى حبها حينما كان يخطو نحو الثلاثين من عمره.. وكان يومئذ أديبا شابا ناضجا وسيما يملأ اسمه عالم الصحافة والأدب، وكانت "مى" أيقونة شغف الكثير من الشعراء والأدباء، وصارت مصدر إلهام لكثير من الكتاب والمثقفين خاصة أن صالونها الأدبي، الذى بدأ عام 1913، كان يعد أبرز صالون أدبى فى مصر فى القرن العشرين، ومن خلال كتاباتها وصالونها دارت فى فلكها الأحداث، فأحبها محمود عباس العقاد وأحمد لطفى السيد، وتبادلا معها رسائل الحب العذرى.
كذلك كانت "مى زيادة" ملهمة للشاعر المرهف "جبران خليل جبران"، ومع ديوانها الأول "أزاهير حب" شَغُف قلبه بها وعشقها فى صمت وأن لم يتقابلا ولو لمرة واحدة وظل يراسلها طيلة عشرين عامًا، وبالرغم من تعلق قلب "مى" بجبران خليل جبران، إلا أن " العقاد" بدا أمره مع "مي" مختلفاً استنادًا إلى عدد من الرسائل المتبادلة بينهما، حيث تضمنت دفاتره عددًا من الرسائل إليها، قال فيها: "كنت أفعل كل ذلك لعلمى بأنها كانت تخاف على كثيرا مع أنها لم تعشقنِ مثلما كنت أنا أعشقها" ووصف حبه لها قائلاً : «الحب الذى جعلنى انتظر الرسالة أو المهاتفة كما ينتظر العاشق موعد اللقاء"، وآخر شيء كتبه كانت هذه الجملة: " أتمنى أن يأتى من بعدى من يفهمنى وينصفني".
وعلى الرغم من ان الوصل لم يكن قائماً فى مثل هذه العلاقة إلا ان إبداع الحبيب المُلَوع والمحروم من ملهمته التى لم تدرِ عن حبه شيئاً كان له مذاقه المميز ووهجه الذى لا ينطفئ وأثره البالغ فى صبا الحالة الإبداعية، وهذا ما عثرت عليه بأصداف ومحارات شاطئى الثالث والأخير عندما أبحرت مع الشاعر العاشق " أحمد رامى " وكوكب الشرق " أم كلثوم"، فكانت "الصب تفضحه عيونه " هى شرارة البدء فى العلاقة الفريدة التى ربطت بينهما، وبتلك القصيدة التى كتبها رامى وغنتها ثومة بدأت علاقتهما التى استمرت 50 عامًا ولم تتوقف إلا بوفاتها عام 1975، وكان لـ"رامى " ذلك الموعد القدرى مع أم كلثوم حيث رأها للمرة الأولى وهى تشدو بتلك القصيدة فى صالة "سانتى" بحديقة الأزبكية، ليفاجأ بكلماته وقد اكتست انفعالاً بصوت تلك الفتاة القروية البسيطة، تلك النبرة المميزة ذات البحة الخفيفة وما يسكنها من عنفوان يستولى عليه ويبعث فى داخله انفعالاً مؤلمًا. كانت قيمة حبه لأم كلثوم تكمن فى انه حب بلا غرض أو أهداف، فظل سنوات يقدم لها قصائده وأغانيه رافضًا أن يتقاضى أجرًا لها، فقد كان مفتونًا بإبداعها وشموخها، يراها كالقيمة التى نعشقها دون مساسها أو حتى الاقتراب منها، فقد وصفها بـ"الأهرامات" و"نهر النيل".
ورغم ذلك الولع الشديد الذى أسر قلب رامى بأم كلثوم إلا أنه أبى يوماً أن يعرض عليها الزواج حتى لا يكون هذا الزواج سبباً فى اعتزالها الغناء نظراً لطبيعته الشرقية والغريزة الذكورية التى كانت ستجعله يستأثر بصوتها ،وما كانت لتسمح له نزعته الفنية والأدبية الأصيلة أن يكبح جماح ابداعها ارضاء لحبه، كما كان على يقين ان الحرمان يعتق القيمة ويصقلها، فإذا ما كان أطفأ ظمأ هيامه ما استطاع ان ينظِم فيها قوله «سهران لوحدى أناجى طيفك السارى»، فظل رامى العاشق العازف عن الارتباط بمحبوبته، مكتفيًا بألا يطفئ جذوة هذا الحب ليظل دافىء الحس ..غزير التعبير .. فتىّ العاطفة بحيث لا تدركها شيخوخة الأيام وبرودة الامتلاك.
وفى لحظة تأمل عميق لماهية هذه العلاقات التى تجولنا بأركانها وما بها من خصوصية أكسبتها حدوداً أبعد مما يمكن إدراكها، تظل " ثقافة الإلهام" ثقافة خاصة جداً تستأثر بها حقبة من أميز حقبنا الإبداعية وتظل " الملهمة " وقوداً لقريحة كل مبدع ومَعبره للخلود، فكلما تعبد فى محراب الغرام، اِكتوَّت روحه باللوعة وانهمر فيض إبداعه، ولكن عذرًا ... فقد اختلف إيقاعنا مع الأسف ولم نعد نلمح تلك الحالة الخاصة ولم نعد نجنى ثمارها الطيبة، لذا نظل نعيش على نفحات عابرة من زمن امتلاء بعطر مؤججة رائحته لا يخمد ولا يتطاير ...نفحات تعتق الإحساس فى قلوب من احتساها شراباً ومن تنفسها هواءً ومن استرقها سماعاً ومن يهفو اليها فى حنين كالذى يعترينا إذا ما تسللت أصداء العندليب " حبيتى ... من تكون " إلى آذاننا!
 طه حسين
طه حسين
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



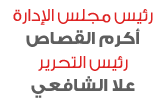








عدد الردود 0
بواسطة:
الشاعر / طارق ناجح
مقالة رائعة
عدد الردود 0
بواسطة:
عزة
لك كل الشكر
عدد الردود 0
بواسطة:
اشرف الشربينى
مقال رائع